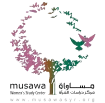648
الانتخابات البرلمانية في سوريا من وجهة نظر نسوية
د. ميّة الرحبي
مقدمة .............................................................................................. 1
سقوط النظام وبدء المرحلة الانتقالية............................................................. 2
مؤتمر الحوار الوطني ............................................................................ 3
الإعلان الدستوري المؤقت........................................................................ 4
الانتخابات في الإعلان الدستوري المؤقت ...................................................... 4
الحكومة السورية المؤقتة ........................................................................ 5
انتخابات مجلس الشعب .......................................................................... 5
لماذا الكوتا النسائية؟ ............................................................................. 11
ما العمل؟ ......................................................................................... 11
مقدمة:
بدأ الحكم الشمولي في سوريا عام 1963 بعد استلام حزب البعث الحكم، والذي تحول إلى حكم عائلي استبدادي للأسدين الأب والابن، امتد من عام 1970 وحتى نهاية 2024، حكم اتسم بالوحشية في معاملة خصومه، وظهرت هذه الوحشية بأبشع مظاهرها بعد اندلاع الثورة السورية السلمية عام 2011، والتي تحولت إلى نزاع مسلح بين النظام والفصائل المسلحة المعارضة له، بتدخل أطراف دولية وإقليمية عدة مناصرة هذا الطرف أو ذاك.
لم يقتصر إجرام العائلة الأسدية على استخدم شتى أنواع الأسلحة ضد معارضيه من قصف وأسلحة كيمياوية، بل اتبع سياسة النهب والفساد والإفساد، واستباحة البلد وأهله.
تسبب النزاع المسلح في مقتل ما لا يقل عن نصف مليون سوري[1]، واختفاء أكثر من 125 ألفاً اختفاء قسرياً، ويقدر عدد النساء المعتقلات والمختفيات قسرياً بأكثر من 10 آلاف حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان[2].
هُجّر ثلثا الشعب السوري تقريباً من أماكن سكانهم الأصلية، نزح نصفهم داخل البلد، وهاجر نصفهم الآخر إلى منافٍ في كافة أصقاع الأرض.
يشير تقرير الاتجاهات العالمية لعام 2022 لل UNHCR إلى وجود 6.5 مليون لاجئ، و6.8 نازح[3]سوري. تعاني معظم اللاجئات في دول الجوار من الفقر والعيش في مخيمات أو مراكز إيواء تفتقر لأبسط الشروط الإنسانية، ما يعرضهن للعنف والاستغلال[4]، من تزويج مبكر والعمل بأجور زهيدة والاستغلال الجنسي[5] وفقدان الأوراق الثبوتية، والقبول بالزواج العرفي غير المسجل.
وبحسب تقارير العديد من المنظمات الحقوقية فقد كان النظام البائد مسؤولاً عن النسبة الأعلى من الانتهاكات.
عاش غالبية الشعب السوري 14 سنة مريرة في فقر مدقع وأوضاع أمنية مروعة. ومورس خلال تلك السنوات كل أشكال القمع والاضطهاد والتنكيل ضد فئات الشعب، وخاصة من اتخذ منهم موقف المعارض للنظام، وزادت العقوبات الاقتصادية غير المدروسة من قبل الدول الخارجية من سوء الوضع وترديه.
تدهور الاقتصاد السوري تدريجياً في السنوات الأخيرة نتيجة عوامل عديدة، أهمها توجيه الموارد نحو آلة الحرب، وقُدر في عام 2022 أنّ 90% من السوريات والسوريين يعيشون تحت خط الفقر، وكان ما لا يقل عن 12 مليون سوري من أصل نحو 16 مليونا من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، حسب "برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة"[6][7]
في أجواء انعدام حس المواطنة يعود المواطنون إلى انتماءات ما قبل الدولة دينية، وطائفية وعرقية ومناطقية، علّهم يجدون فيها ملاذاً وحماية من نظام يستبيح حياة أي مواطن دون مساءلة أو محاسبة، في ظل فوضى أمنية وانعدام سيادة القانون. وقد ساهم النظام الأسدي في تغذية تلك الانتماءات وتأليبها ضد بعضها البعض تكريساً لسيطرته على البشر. ونشأت مظلوميات وأحقاد لم يجرؤ الناس على الجهر بها علناً، فكانت تتضخم في القلوب وخلف الجدران بصمت، خاصة أن النظام الأسدي اصطبغ بصبغة طائفة، استفاد قلة منها، ودفع غالبيتها ثمن حكم العائلة الأسدية باسمها.
تخللت سنوات الحكم الأسدي هده انتخابات تشريعية، كان الترشيح والانتخاب فيها شكلياً يتم تحت سيطرة الأجهزة الأمنية، التي كانت ترشح من تشاء، وتنتخب من تشاء، بمعيار الانتهازية والولاء للنظام الحاكم.
سقوط النظام وبدء المرحلة الانتقالية:
أسقطت مجموعة من الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام النظام البائد في 8 كانون الأول 2024، ليبدأ عهد جديد في سوريا، بتركة ثقيلة تركها النظام الاستبدادي، ودخلت سورية عهداً جديداً، يبدأ بما اصطلح على تسميته دولياً بالمرحلة الانتقالية، والتي تحاول القوة التي استلمت السلطة خلالها اكتساب الشرعية على المستويين الداخلي والدولي، كي تستطيع إدارة شؤون الدولة وتمثيلها.
وكان لابد لها لاكتساب هذه الشرعية من القيام بإجراءات ذات طابع متعارف عليها دولياً، كالحوار الوطني والدستور المؤقت وانتخابات مجلس الشعب، وهي إجراءات مستمدة من النظام الديمقراطي، حتى ولو كانت شكلية ولا تعبر عن جوهر الديمقراطية المرتكز على القيم التي تحمي الحقوق والحريات الفردية والعدالة والمساواة.
في 29 كانون الثاني، تم الإعلان عن حل مجلس الشعب، خلال "مؤتمر النصر" الذي شاركت فيه فصائل المعارضة المسلحة التي أطاحت بنظام الأسد، وشهد المؤتمر تنصيب الشرع رئيساً للبلاد، وبالطبع حضر المؤتمر ممثلو الفصائل من الرجال بغياب أي عنصر نسائي. ولم يكن خافياً على أحد الطبيعة الإسلامية الجهادية التي تميّز أغلب تلك الفصائل.
بدا منذ الأيام الأولى لاستلام الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام أن الصفات الغالبة عليها الانغلاق والحذر، حتى من بعضها البعض، ورفضها الانفتاح أو التشاور حتى مع جهات المعارضة السورية أو منظمات المجتمع المدني التي نشأت بعد الثورة، وكان لها دور فاعل، حتى أنها حملت في بعض المناطق المسؤوليات التي تحملها الدولة عادة.
وكان لابد لهيئة تحرير الشام التي أوكل إليها قيادة الحكومة المؤقتة، بعد مبايعة الفصائل الأخرى، أن تقع تحت وطأة أعباء ثقيلة، على رأسها بسط سيطرة الدولة والأمن في أنحاء البلاد، وإدارة مؤسسات الدولة، واكتساب الشرعية على المستويين المحلي والدولي، لذا ظهر التناقض واضحاً في كل القرارات التي اصدرتها، والتي تأرجحت بين محاولة إرضاء الفصائل المسلحة، والتي حمل بعضها فكرا تكفيرياً جهادياً متطرفاً من جهة، والمجتمع الدولي من جهة أخرى سعياً إلى اكتساب الشرعية ورفع العقوبات ودعم إعادة الإعمار. وقد وسم هذا التناقض جميع الآليات "الديمقراطية" التي أنجزتها الحكومة المؤقتة، ما حولها إلى آليات شكلية، قد ترضي المجتمع الدولي، إلا أنها ستزعزع يوماً بعد يوم الثقة بين أفراد الشعب والسلطة القائمة، خاصة بعد الأحداث الدموية، ذات الصبغة الطائفية، التي حدثت في الساحل والسويداء.
وكان واضحاً اختيار الأشخاص في جميع الهيئات التي شكلت الحكومة من الدائرة الضيقة التي تتفق معها برؤاها، مع تطعيم تلك الهيئات بعدد قليل من الأشخاص من خارج تلك الدائرة، كإجراء شكلي يعبر عن الشمولية.
مؤتمر الحوار الوطني:
عقد مؤتمر الحوار الوطني في 25 شباط 2025، والذي لا يمكننا توصيفه بأكثر من اجتماع شكلي لمواطنين، تم اختيارهم من دون أي معايير واضحة، خاصة بعض رفص الحكومة المؤقتة لدعوة أي شخص كممثل لقوى المعارضة السياسية أو الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني، والتي لم تعترف القوة التي استلمت الحكم في سوريا بوجودهم أصلاً.
لم يدم الحوار في المؤتمر الوطني لأكثر من أربع ساعات، ومن ثم أعلن البيان الختامي معتمداً العديد من المخرجات أهمها:
الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها على كامل أراضيها، حصر السلاح بيد الدولة، والعمل على إعلان دستوري مؤقت، وتشكيل مجلس تشريعي مؤقت، وتعزيز الحريات واحترام حقوق الإنسان، وترسيخ مبدأ المواطنة، دون تمييز، والتعايش السلمي والعدالة الانتقالية، والتنمية السياسية على أساس المشاركة، وإطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.[8] لا يوجد إحصاء دقيق لنسبة تواجد النساء اللاتي حضرن المؤتمر ولكنه قدر بحوالي 20%، وقد ذُكر عرضاً في مخرجات المؤتمر جملة دعم دور المرأة في كافة المجالات، وضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع.
الإعلان الدستوري المؤقت:
شُكّلت لجنة لصياغة الإعلان الدستوري المؤقت، لم يكن من ضمنها الحقوقيون الدستوريون السوريون المعروفون بخبرتهم في هذا المجال، وأصدرت الرئاسة السورية في 13 آذار 2025 الإعلان الذي أكد على:
- الدولة: سورية دولة مستقلة موحدة، نظامها يقوم على الفصل بين السلطات والمساواة بين المواطنين.
- الحقوق: ضمان حقوق الإنسان، حرية التعبير والمشاركة السياسية، وحماية المرأة والطفل ومنع التعذيب.
- السلطات: مجلس شعب مؤقت، رئيس جمهورية وحكومة لتنفيذ القوانين، وقضاء مستقل مع محكمة دستورية جديدة.
- العدالة الانتقالية: إلغاء القوانين القمعية، إنصاف الضحايا، وتجريم تمجيد نظام الأسد أو إنكار جرائمه.
- المرحلة الانتقالية: مدتها 5 سنوات تنتهي بدستور دائم وانتخابات عامة.
وقد قدمت دراسة لمحتواه ومن وجهة نظر نسوية، يمكن للمهتم العودة إليها[9] وخلاصتها أن الإعلان الدستوري السوري الجديد، لم يختلف جوهرياً في موقفه من المرأة عن الدساتير أو الإعلانات الدستورية السورية السابقة، فهو لم ينص على ضمانات حقيقية لحقوق النساء. واستند إلى الفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع، وأعطى الطوائف الدينية حق صياغة قوانين أحوال شخصية خاصة بها، ما يفتح الباب للإبقاء على قوانين أحوال شخصية مميزة ضد النساء، ويجعل المساواة المعلنة في بعض المواد متناقضة مع الواقع.
وكان من أبرز النقاط المتعلقة بالمرأة في الإعلان الدستوري:
- تكريس التمييز ضد النساء في الأسرة والأحوال الشخصية، رغم الاعتراف بحقوقهن في الحياة العامة.
- غياب نص يضمن حق المرأة في منح جنسيتها لعائلتها.
- إغفال آليات خاصة لحماية ضحايا العنف الجنسي ضمن العدالة الانتقالية.
- احتفاظ النص بلغة مذكرة لا تراعي المساواة بين الجنسين.
- الاعتراف لأول مرة بحق حماية النساء من القهر والعنف، لكن دون تحديد آليات للتنفيذ.
- غياب مبدأ الكوتا النسائية أو ضمان التمثيل السياسي المتكافئ.
الانتخابات في الإعلان الدستوري المؤقت
نصّت المادة (24) من الإعلان الدستوري على أن يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، فيما ستبلغ مدة ولاية المجلس 30 شهراً قابلة للتجديد.
ويتولى مجلس الشعب وفقاً للمادة (30) مجموعة من المهام، تشمل اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وإقرار العفو العام.
بينما تنص المادة (38) على أن يُصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، وله الاعتراض عليها خلال شهر من تاريخ ورودها من المجلس الذي يعيد النظر فيها، ولا تقر القوانين بعد الاعتراض إلا بموافقة ثلثي مجلس الشعب، وفي هذه الحالة يصدرها رئيس الجمهورية حكماً.[10]
لم ترد في الإعلان الدستوري كلمة ديمقراطية لكن الآليات التي تضمنتها مواده هي آليات مستمدة من النظام الديمقراطي كالانتخابات والسلطات الثلاث ومن بينها السلطة التشريعية التي يفترض أن يُمثل أعضاؤها الشعب عن طريق انتخابات حرة.
كما لم يرد في المواد المتعلقة بالانتخابات أي إشارة إلى المشاركة السياسية للمرأة، أو أي إجراءات انتخابية تشجع على ذلك، كالكوتا النسائية.
الحكومة السورية المؤقتة:
في 29 آذار 2025، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم 9 لعام 2025[11]، القاضي بتشكيل الحكومة السورية الانتقالية ومجلس الوزراء رقم 98 في تاريخ الجمهورية السورية. وقد ضمّ التشكيل الوزاري الجديد 22 وزيراً من الذكور ووزيرة واحدة هي السيدة هند قبوات. وضمّ التشكيل وزيرين سابقين في حكومات بشار الأسد، هما يعرب بدر ومحمد نضال الشعار، إضافة إلى ثمانية وزراء يمثلون هيئة تحرير الشام، من بينهم وزراء شغلوا مناصب سابقة في حكومة الإنقاذ (الحكومة التي شكلتها هيئة تحرير الشام في إدلب).
وهنا برز التهميش الواضح لدور النساء بتعيين وزيرة واحدة من أصل 22 وزيراً.
انتخابات مجلس الشعب:
لا يخفى على أحد التحديات الجمّة التي تواجهها أي حكومة انتقالية لديها النيّة الحقيقية بإجراء انتخابات برلمانية حرّة نزيهة، تغبر فعلاً عن كل أطياف المجتمع، ومن هذه التحديات:
- التحديات الأمنية
- استمرار خطر العنف أو الهجمات من جماعات مسلحة يمكن أن يعرقل عملية الاقتراع أو يثني الناخبين عن المشاركة.
- صعوبة تأمين مراكز الاقتراع وحماية القضاة، الموظفين، والمراقبين.
- احتمال استخدام السلاح أو الترهيب للتأثير على إرادة الناخبين.
- التحديات السياسية
- انعدام الثقة بين الأطراف السياسية والمجتمعية نتيجة النزاع السابق.
- احتمال مقاطعة بعض الفصائل أو التشكيك في شرعية الانتخابات إذا شعروا بعدم تمثيلهم أو بوجود تمييز.
- ضعف المؤسسات الانتقالية أو حداثة التجربة الديمقراطية، ما يجعل الإدارة الانتخابية عرضة للضغط أو الاختراق.
- التحديات المرتبطة بالمهجرين واللاجئين
- صعوبة تمكين المهجرين واللاجئين من ممارسة حقهم الانتخابي بسبب تواجدهم خارج البلاد أو في مناطق نائية.
- مشكلات لوجستية وقانونية تتعلق بآليات تسجيلهم وتصويتهم (هل عبر السفارات، البريد، أو العودة المؤقتة؟).
- احتمال تهميش أصواتهم، مما يؤثر على شمولية وعدالة العملية الانتخابية.
- التحديات المتعلقة بالأوراق الثبوتية
- فقدان أعداد كبيرة من المواطنين لوثائقهم الرسمية بسبب النزوح أو الدمار، ما يحرمهم من التسجيل والتصويت.
- مخاطر التزوير إذا جرى استخدام وثائق بديلة أو مؤقتة دون آليات تحقق قوية.
- الحاجة إلى إنشاء نظام تحقق بيومتري أو سجلات بديلة في وقت قصير وهو أمر مكلف وصعب.
- التحديات الإدارية واللوجستية
- ضعف البنية التحتية (طرق، اتصالات، كهرباء) بفعل الحرب.
- نقص الكوادر الإدارية المدربة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.
- الحاجة لتمويل خارجي وضمانات رقابية دولية، مع ما يحمله ذلك من تحديات سيادية.
- التحديات الاجتماعية
- انتشار الخوف وانعدام الثقة في المؤسسات، ما قد يؤدي إلى عزوف جماهيري.
- الانقسامات المجتمعية (عرقية، دينية، مناطقية) قد تترجم إلى صراع انتخابي بدلاً من تنافس سياسي صحي.
في ظل تلك التحديات قد تختار الحكومة المؤقتة آليات انتخابية تختلف عن تلك الآليات التي تتبع عادة في البلدان المستقرة سياسياً، ولكن مهما كان النظام الانتخابي الذي يمكن اختياره فلن ينجح في نيل ثقة الشعب إذا لم يتوفر فيه شروط عدّة أهمها:
- الشمولية: بحيث يكون هنالك مندوبون يعبرون عن كل فئة منطقة وفئة مجتمعية وخاصة النساء والشباب والمهجرون والأقليات، بحيث لا يستثنى أي طيف من أطياف الشعب من هذه المعادلة.
- الرقابة المستقلة: القضاء، منظمات المجتمع المدني، والمراقبون الدوليون سيشرفون على العملية لضمان الحياد والنزاهة
- الشفافية الكاملة بحيث تعرف جميع أسماء المندوبين ومعايير اختيارهم ، وتكون جلسات الاختيار والقرارات متاحة للجمهور والإعلام.
أولاً: تشكيل اللجنة العليا للانتخابات
في 13 حزيران 2025 صدر المرسوم الرئاسي لاقم 66 لعام 2025 بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب[12] من 10 أشخاص بينهم سيدتان. وكلّف اللجنة العليا للانتخابات بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، تنتخب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، في حين يعين الرئيس الشرع الثلث الباقي.
بعد تشكيلها أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنها نفذت زيارات ميدانية إلى كافة المحافظات السورية حيث التقت بثلاث شرائح من المواطنين:
- السلطات المحلية ممثلة بالمحافظين ومديري المؤسسات الرسمية في المحافظات.
- ممثلو المجتمع المحلي والهيئات الأهلية والشعبية.
- رموز المنطقة ووجهاؤها.
وأوضحت أن الغاية من هذه اللقاءات استمزاج الرأي العام حول نظام الانتخابات المؤقت، والبرنامج الزمني لانتخابات، إضافة إلى الشروط والمعايير المطلوبة وتوزيع المقاعد على المحافظات والمناطق[13].
ولم يأت الخبر الرسمي الذي نشر على الصفحة الخاصة بمجلس الشعب بأي ذكر للقاءات ستجرى مع فعاليات سياسية أو مدنية (منظمات مجتمع مدني، نقابات)، أو هيئات المعارضة السورية، والتي عملت جميعها خلال الأربعة عشر سنة الماضية على وضع تصورات ودراسات وأبحاث عن الآليات التي يمكن أن تتم بها الانتخابات خلال الفترة الانتقالية، ومن بينها تلك التي قامت بها العديد من المنظمات النسوية والمدافعة عن حقوق النساء.
وكما هو متوقع لم تمثل النساء في الشرائح الثلاث، فغالباً ما تكون الشرائح السابقة ممثلة برجال، وهذا ما حدث فعلا، إذ غاب العنصر النسائي عن جميع هذه اللقاءات غياباً شبه كامل، كما أوضحت الأخبار والصور التي نشرت عن هذه اللقاءات. وقد رشح من تلك القاءات وتصريحات اللجنة العليا للانتخابات أن تواجد النساء في مجلس الشعب سيكون محدداً بنسبة 20%.
عقدت اللجنة العليا للانتخابات لقاءً وحيداً مع ممثلات بعض الهيئات والمنظمات المدافعة عن حقوق النساء، تحدث فيه عضو اللجنة حسن الدغيم عن أن النقاش تضمن "أهمّية استمزاج في الآراء بين المواطنين، حيث تضمن نقاش اليوم نسبة تمثيل المرأة وذوي الإعاقة وفئة الشباب في المجلس".
كما صرحت عضوة اللجنة لارا عيزوقي: “إن هذه اللقاءات مع مختلف الشرائح إضافة إلى الجولات التي قمنا بها في المحافظات من شأنها إغناء العمل، عن طريق الاستماع إلى مختلف الآراء والطروحات والنقاش حولها”، مبينة أهمية دور المرأة في العمل السياسي والبرلماني، وأن تكون نسبة مشاركتها مرتفعة استناداً إلى الكفاءة والقدرة على العطاء بشكل فاعل وحقيقي في كل مفاصل الحياة.
في حين طالبت ممثلات المنظمات النسائية برفع نسبة مشاركة المرأة في المجلس من 20 إلى 30% كحد أدنى، لدورها المهم الذي برز رائداً خلال العقود الماضية وخاصة خلال سنوات الحرب، داعيات إلى العمل على تحسين نظرة المجتمع للمرأة، وزيادة الحرص على توفير جو آمن من كل الأخطار المحتملة لإجراء العملية الانتخابية، وتحقيق أعلى قدر ممكن من العدالة في توزيع المرشحين وتمثيلهم لمحافظاتهم.
من جهتها أشارت رواد إبراهيم عضوة منظمة مساواة إلى ضرورة رفع نسبة تمثيل النساء في العملية الانتخابية والمجلس وصولاً إلى تحقيق مساواة كاملة بين المرأة والرجل، مؤكدة أهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على هذا الجانب والعمل لدعم المرأة في تلبية مطالبها[14].
بعد تلك اللقاءات أنجزت اللجنة العليا مسودة النظام الانتخابي وقدمته إلى رئاسة الجمهورية.
ثانياً: النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب
صدر عن رئاسة الجمهورية المرسوم رقم 143 الخاص بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب بتاريخ 20/8/2025 [15].
حدد المرسوم في مادته الثانية عدد أعضاء مجلس الشعب ب 210، ينتخب الثلثان منه وفق النظام الانتخابي ويعين الثلث الباقي من قبل رئيس الجمهورية.
كما حدد المرسوم الآليات التي ستتم فيها الانتخابات.
في المادة (9) تشكّل اللجنة العليا لجاناً فرعية في المحافظات مهمتها تنظيم الانتخابات في المنطقة.
ووزعت المقاعد على المحافظات السورية على الشكل التالي:
حلب (32)، دمشق (10)ريف دمشق (12)حمص (12)حماة (12)إدلب (12)اللاذقية (7) دير الزور (10)الحسكة (10)طرطوس (5)درعا (6)الرقة (6)السويداء (3)القنيطرة (3).
وقسّمت كل محافظة إلى عدة دوائر انتخابية. حسب قرار اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب رقم 24 الصادر في 26 آب/أغسطس 2025، حيث ستجري الانتخابات في 60 دائرة انتخابية.
وحددت المادة (5) عدد أعضاء الهيئة الناخبة في كل دائرة انتخابيّة، بعدد المقاعد المخصّص لتلك الدّائرة مضروباً بالرقم خمسين (50).
وفي المادة 10 من المرسوم حددت شروط عضوية اللجنة الفرعية والتي شملت بعض المواد ذات المفاهيم المطاطة غير الواضحة قانونياً، والتي يمكن تفسيرها تفسيرات شتى يستبعد على أساسها الشخص مثل: ألا يكون من داعمي النظام البائد والتنظيمات الإرهابيّة بأي شكل من الأشكال، وألا يكون من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج، أو أن يكون على معرفة واسعة بكفاءات وأعيان دائرته الانتخابيّة، أو ألا يكون له عداوة ظاهرة مع أيّ من مكوّنات دائرته الانتخابيّة.
وهنا يمكن إسباغ تهمة الاستقواء بالخارج على أي شخص منتم إلى منظمة مجتمع مدني ذات علاقة أو تتلقى تمويلاً من جهة دولية، وعلى الأخص الناشطات النسويات اللاتي سبق وأن طالتهن حملة منظمة في المناطق التي كانت تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، حيث تم اتهامهن علناً بأنهن يعملن ضمن "مؤسسات تبدأ بالأمم المتحدة وتصل إلى «منظمات بعناوين خيرية، عناوين إغاثية، عناوين تنموية، عناوين تدريبية» جندت «نساء من أبناء جلدتنا» لينشرن «بين فتياتنا خاصة، ما يسمونه بتحرير المرأة، ما يسمونه بالجندر، وأن تُمكَّن المرأة من حريتها»، عبر دورات مجانية «بعناوين مغرية ولكن فيها السم». هذا «أخطر من معركة القتال»".[16]
وفي المادة 13 تقوم اللجنة الفرعيّة باقتراح القائمة المبدئيّة لأعضاء الهيئة النّاخبة إلى اللجنة العليا.
وتحدد المادة 21 شروط العضوية في اللجان الناخبة وفيها بعض الشروط المبهمة والتي يمكن تفسيرها تفسيرات عديدة مثل: ألا يكون من داعمي النظام البائد والتنظيمات الإرهابيّة بأي شكل من الأشكال، وألا يكون من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج.
وتحدد المادة 22 مفهوم فئتي الكفاءات والأعيان اللتين سيتم اختيار اللجان الناخبة منهما بما يلي:
-
- يُقصد بفئة الكفاءات الأشخاص الحاصلون على مؤهلات جامعية في مختلف الاختصاصات.
- يُقصد بفئة الأعيان الشخصيات ذات التأثير الاجتماعي، ممن يعرفون بالنشاط والخدمات المجتمعية.
وتجاهلت هذه المادة تمثيل الهيئات المدنية والسياسية بأشخاص ضمن اللجان الناخبة.
أما آلية اختيار أعضاء اللجان الناخبة فيتم تحديدها بالمادة 23 وهي آلية التشاور التي تقوم بها اللجان الفرعية مع الفعاليات المجتمعية والرسمية (وهي على ما يبدو نفس الشرائح الثلاث التي حددتها اللجنة العليا في المشاورات التي سبقت صياغة النظام الانتخابي). ومن ثم ترفع اللجنة الفرعية قائمتين تشملان “قائمة الأعيان” و” قائمة الكفاءات” إلى اللجنة العليا التي تعتمدها ما لم تعترض لجنة الطعون عليها.
وتكمن المفاجأة الحقيقية في النظام الانتخابي هذا في المادتين 24 و26.
حيث تنص المادة 24 على أن يُرَاعى – ما أمكن – في اختيار أعضاء الهيئة النّاخبة الأمور الآتية:
- أن تكون نسبة الكفاءات (70) %، ونسبة الأعيان (30) %.
- التنوع المجتمعي والتوزع السكاني في الوحدات الإدارية ضمن الدائرة الانتخابية.
- تنوع الاختصاصات في قائمة الكفاءات.
- تمثيل المهجّرِين داخلياً وخارجياً.
- تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن عشرين بالمئة من عموم الهيئاتِ الناخبة.
- تمثيل ذوي الشُهداءِ ومصابي الثورة وِذْوِي الإعاقة والناجين والناجيات من الاعتقال.
فما هو مفهوم الكفاءات وما هو مفهوم الأعيان قانونياً؟ صحيح أن المادة 21 تشترط أن يكون الشخص من قائمة الكفاءات حاصلاً على شهادة جامعية معتمدة أو ما يعادلها، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية بالنسبة لفئة الأعيان، ولكن هل هذا المعيار كافٍ؟
كما يرد في المادة على أنه يراعى ما أمكن تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 20%، أي أن النسبة قد تكون أقل من ذلك وهذا هو الأرجح، كونهن أصلاً لم يكن متواجدات بما يكفي في عملية التشاور.
وبذا ذهبت أدراج الرياح جميع الجهود التي قامت بها المنظمات النسوية السورية في العقدين الماضيين من أبحاث ودراسات وتدريبات وحوارات مجتمعية عن أهمية المشاركة النسائية في الحياة العامة وخاصة الحياة السياسية، وأهمية تواجدهن في مواقع صنع القرار، وأهمية تطبيق الكوتا النسائية بنسبة لا تقل عن 30% سعياً إلى المناصفة مستقبلاً، إذ لا يمكن الادعاء بتمثيل شعب، نصفه غير ممثل في مجلس الشعب، ولا يوجد من يحمل صوته واحتياجاته ومطالبه إلى الساحة السياسية الوطنية.
لكن المفاجأة الأكبر تكمن في المادة 26 والتي تحصر التَرشُحُ لعضويّة مجلس الشّعب بأعضاء الهيئات النّاخبة المعتمدة في القوائم النهائيّة، وضمن دوائرهم الانتخابيّة. وتنص المادة 28 على أن المرشّح يجب أن تنْحَصر دعايته الانتخابيّة ضمن الهيئة الناخبّة.
هنالك موضوع آخر لابد من الانتباه إليه في حال حصول انتخابات حرّة في سورا مستقبلاً، وهو موضوع اشتراط أن تكون المنطقة التي يمكن أن يرشح فيها الشخص نفسه للانتخابات هي المنطقة التي يوجد فيها سجله المدني، لا المنطقة التي يقيم فيها، وهذا غير واقعي، بعد حركة النزوح الكبيرة من الريف إلى المدينة، التي تمت خلال العقود السابقة أو التي تمت خلال النزاع المسلح، بحيث يوجد الكثير من الأشخاص الذين أقاموا وباشروا نشاطهم المجتمعي والمدني في مناطق جديدة، وغدوا مطلعين على أحوالها، ومعروفين من قبل مجتمعاتها، في حين تكون معرفتهم سطحية بأحوال المجتمع في مناطق سجلاتهم المدنية، وغير معروفين فيها، ففي هذه الحالة لا يمكن اعتبارهم ممثلين لمناطقهم الأصلية، وستكون فرص نجاحهم في الانتخابات ضئيلة فيها، ومن المنطقي أن يكون ترشيحهم على أساس مكان إقاماتهم، لا على أساس أمكنة سجلاتهم المدنية. وهذا ما يؤثر خصوصاً على فرص النساء في الفوز بالانتخابات، نظراً لعدم امتلاك المرأة في سوريا لسجل مدني مستقل، فهي تكون مسجلة في سجل عائلتها، ومن ثم ينتقل تسجيلها إلى سجل زوجها، ليعود تسجيلها إلى سجل عائلتها في حال طلاقها، وهذا أحد الأسباب إضافة لأسباب أخرى عديدة جعلت من مطالبة المدافعات عن حقوق النساء بسجل مدني مستقل للمرأة أحد المطالب المشروعة.
ثالثاً: الاستنتاجات:
إذاَ الرئيس هو من عين اللجنة العليا للانتخابات، والتي عينت اللجان الفرعية، والتي بدورها عينت اللجان الناخبة، التي يحصر ضمنها الترشح وانتخاب أعضاء مجلس الشعب، مع وجود مفاهيم فضفاضة وتهم جاهزة يمكن أن تلصق بأي كان لاستبعاده عن التعيين في اللجان الانتخابية، وبالتالي اختياره لعضوية مجلس الشعب.
والخلاصة أن النظام الانتخابي برمته هو نظام تعيين لأعضاء مجلس الشعب من قبل السلطة التنفيذية، ما يضع شرعيته كلها كسلطة تشريعية مستقلة موضع تساؤل، فهل سيمثل مجلس الشعب المنتخب بهذه الآلية الشعب حقاً؟ وهل يمكن أن تكون السلطة التنفيذية في موقع مساءلة من قبل مجلس قامت هي نفسها بتعيينه؟
تُختزل الديمقراطية في العلوم السياسية عادةً في بعدين رئيسيين:
- البعد الإجرائي (Procedural): يركز على الآليات مثل الانتخابات الحرة والنزيهة، الفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة.
- البعد الجوهري (Substantive): يركز على القيم التي تحمي الحقوق والحريات الفردية، العدالة، والمساواة، وليس فقط الإجراءات الشكلية.
وباعتقادنا فإن النظام الانتخابي المؤقت لن يكون سوى ألية شكلية، لا تفرز تمثيلاً حقيقياً للشعب، وكان يمكن تدارك ذلك بآليات تسمح بإشراك المجتمع المدني والمهجرين، مع كوتا نسائية لا تقل عن 30%، وآلية رقابة تتضمن إشراك منظمات مجتمع مدني محلية ومنظمات دولية مستقلة، خاصة بوجود أجواء من انعدام الثقة الآن بين الحكومة وشرائح مجتمعية عدة بعد الأحداث المؤلمة التي حدثت في الساحل والسويداء، واستياء الكثير من فئات الشعب لاستبعادهم تماما من العملية الانتخابية ذات المعايير الغامضة، والتي اعتمدت على التقسيم الجغرافي والزعامات المحلية، والتي تتألف غالباً من رجال دين وشيوخ عشائر، وإرجاء الانتخابات في المناطق التي لا زالت غير مستقرة أمنياً، إضافة إلى انعدام الشفافية التي شكلت جداراً عازلاً بين السلطة وأفراد الشعب، الذين باتوا يشعرون أنهم خارج المعادلة تماماً في تقرير مصيرهم ومصير البلاد برمتها.
إضافة إلى ذلك كله بدا واضحاً من القرارات والإجراءات التي مارستها الحكومة المؤقتة، أنها تهمش النساء، وتعتمد الصورة النمطية لهن والتي برزت واضحة في المادة 21 من الإعلان الدستوري بعبارة "تحفظ الدولة المكانة الاجتماعية للمرأة، وتصون كرامتها ودورها داخل الأسرة والمجتمع"، فالعقلية التي تتبناها الحكومة المؤقتة لا تنظر للنساء على أنهن مواطنات كاملات الأهلية، يمتعن بالكفاءة التي تؤهلهن للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة، بل تحصر دورهن الأساسي في العناية بالأسرة أولاً كأمهات ومربيات.
لذا لا نعتقد أنه سيكون للنساء حصة كافية ضمن نسبة ال 70% التي حددها في النظام الانتخابي للكفاءات، وقد يتم اختيار نسبة ضئيلة منهن كواجهة للتنوع تحتاجها الحكومة، عدا أنهن مستبعدان بالطبع تماماً من نسبة 30% التي حُددت للأعيان، والذين هم دائماً من الرجال.
لماذا الكوتا النسائية؟
طالبت المنظمات المدافعة عن حقوق النساء منذ أيام ربيع دمشق عام 2000 وإلى اليوم بكوتا نسائية لا تقل عن 30% سعياً إلى المناصفة مستقبلاً، في جميع مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، كتعويض عن الظلم التاريخي المتمثل باستبعاد النساء اللاتي يمثلن نصف الشعب عن إدارة مؤسسات الدولة ورسم خطط وسياسات الحكومات، وتضمين احتياجات النساء ومطالبهن في تلك الخطط.
وقد طبق نظام الكوتا النسائية في العديد من دول العالم كإجراء مؤقت ومدخل لتذليل العقبات أمام التمثيل النيابي للمرأة، حتى يصبح وجود المرأة في البرلمان أمرًا واقعًا يتقبله المجتمع، ووقد أثبت نظام الكوتا نجاحه في العديد من دول العالم التي تمرست فيها النساء في المجال السياسي نتيجة تطبيقه، بحيث لم تعد النساء بحاجة إليه للوصول إلى مراكز صنع القرار في السلطات الثلاث.
وحسب قاعدة بيانات "Gender Quotas Database"، تهدف النظم المعاصرة للكوتا إلى ضمان وجود أقلّ نسبة فعّالة تتراوح بين 20% و40%، مع وضع سقف وسطٍ فعال غالباً ما يقع حول 30%؛ حيث تُعتبر هذه النسبة ضرورية لوجود تأثير حقيقي وليس مجرد حضور شكلي (International IDEA) ، فنسبة أقل مثل 10–20% لا تكفي لتكوين كتلة حرجة مؤثرة، أما 30% فأكثر يجعل النساء قادرات على التأثير والمشاركة الفعلية في التشريع، ويُتيح لهن مجالا أكبر لتغيير السلوكيات السياسية السائدة.
ما العمل؟
ما الذي يمكننا فعله اليوم كمنظمات وناشطات مدافعات عن حقوق النساء؟
بداية نحن لا نؤمن بالعنف، ولا بالحلول المسلحة لتحقيق تطلعات وأماني الشعوب، بل نناضل سلمياً للوصول إلى القيم العليا التي نؤمن بها لتحقيق السلام والأمان والعدالة والمساواة وضمان حقوق كل أفراد الشعب في دولة تقوم على أساس المواطنة المتساوية دون تمييز بين المواطنين على أي أساس كان. كما أننا نؤمن بالديمقراطية الحقّة التي يحكم بها الشعب نفسه بنفسه ويوصل ممثليه بآليات ديمقراطية حرة ونزيهة لإدارة البلاد بما يحقق السلام والعدالة والازدهار للبلد ومواطنيه، ومستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة.
قد يبدو في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد، وحالة الضياع والتشتت التي تسيطر على السوريين بشكل عام، والناشطين بشكل خاص، استحالة الوصول سريعاً إلى ما كنا نطمح إليه من دولة ديمقراطية قائمة على أساس العدال والمواطنة المتساوية وسيادة القانون، إلا أننا كنسويات وضعنا نصب أعيينا أن النضال النسوي هو نضال طويل الأمد، لا يهدف فقط إلى الاعتراف بحقوق النساء ومناهضة كل أشكال التمييز والعنف ضدهن، بل على مبادئ نصرة المظلوم واللاعنف وإحلال السلام واتباع الحلول السلمية لحل أي نزاع أو اختلاف، ما يقود إلى ضرورة الاستمرار في النضال السلمي لتحقيق هذه المبادئ.
ولازالت المنظمات المدافعة عن حقوق النساء مستمرة في العمل على:
- حشد الطاقات للضغط على اللجان الفرعية لاختيار أكبر عدد ممكن من النساء في اللجان الانتخابية، ومن ثم ترشيحهن وانتخابهن بأعلى نسبة ممكنة، إذ تجتمع المدافعات عن حقوق النساء الموجودات في بعض المحافظات السورية، وخاصة في مدينة حلب بهذا الهدف.
- الدعوة المستمرة إلى إنهاء العنف، وتعزيز السلم الأهلي، ومحاربة خطاب الكراهية، الذي تصاعد مؤخراً وبات يهدد بشكل خطير تماسك المجتمع. وذلك بنشر رسائل التماسك الاجتماعي، عن طريق الحوارات المستمرة ونشر أفكار السلم الأهلي، والتنبيه إلى مخاطر النزاع المسلح الذي سيقود فقط إلى مزيد من الضحايا وتمزيق الوحدة الوطنية، واستلهام التجارب التاريخية من الدول الأخرى، التي لعبت فيها النساء دوراً حاسماً في تثبيت السلم الأهلي وحل النزاعات.
- الضغط من أجل بناء دولة تشاركية تشميلية: بدستور وقوانين تنص على المواطنة المتساوية دون أي تمييز، والضغط في سبيل ذلك على إشراك النساء في جميع الهيئات والمؤسسات المعنية بنسبة لا تقل عن 30% سعياً إلى المناصفة، وخاصة في لجنة صياغة الدستور الدائم.
- الضغط للوصول إلى التعافي الاقتصادي والاجتماعي: بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتمكين المرأة والشباب، وتعبئة جميع الجهود لإعادة الإعمار بسياسات تتحرى مصلحة المواطن السوري، وتحفظ حقوق المواطنين نساءً ورجالاً.
- المساهمة في كل الجهود التي تحقق العدالة الانتقالية: بتعزيز الوعي بحقوق المرأة، والتأكيد على مشاركتها في جميع لجان العدالة الانتقالية، ودعم ضحايا العنف، وخاصة النساء منهن، بتأمين الحماية لهن، لتشجيعهن على تقديم الشكاوى، دون الخوف من العواقب الاجتماعية الناتجة عن ذلك، ودعمهن في مسار التقاضي وجبر الضرر.
- التعليم والتوعية: التركيز على ضمان حق التعليم للفتيات والفتيان، خاصة من حرموا منه خلال سنوات النزاع المسلح، والتطبيق الجاد لقانون التعليم الالزامي، ومحو الأمية، وتغيير المناهج التعليمية والحرص على تضمينها المبادئ العالمية لحقوق الإنسان والتعريف بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ونشر الوعي المجتمعي بمفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة.
- ضمان الحقوق القانونية والمدنية بتأمين الوثائق المدنية للجميع.
- الضغط من أجل تغيير جميع القوانيين المميزة ضد المرأة، واستصدار قانون يناهض ويجرم العنف ضد النساء، والذي يشكل عائقاً رئيسياً أمام مشاركتها في الحياة العامة، وخاصة الحياة السياسية.
- دعم المجتمع المدني: الدعوة إلى حرية حركة وعمل منظمات المجتمع المدني، ودورها في حوكمة المرحلة الانتقالية.
- انتخابات نزيهة: الدفع نحو قانون انتخابات دائم يضمن انتخابات شفافة وشاملة، مع إقرار كوتا نسائية لا تقل عن 30%، ونظام تمثيل نسبي يعزز المشاركة السياسية للمرأة.
[1] المرصد السوري: مقتل أكثر من نصف مليون شخص منذ بداية الثورة السورية، جلال بكور
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9، جلال بكور
[2]https://snhr.org/arabic/2022/11/25/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85/
[4] https://www.wvi.org/ar/newsroom/syria-crisis-response/bynma-yrkwz-alalm-ly-azmt-awkranya-ykafh-alnsa-walatfal-fy-mkhymat
[6]https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000149567/download/?_ga=2.35589473.130421442.1698771698-2020907709.1698771698
[8] https://www.facebook.com/sana.gov/posts/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85/627353280028103/
[9] https://musawasyr.org/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9
[10] https://shaam.org/news/syria-news/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9